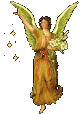معركة المؤمن الحقّ بيسوع
* الأرشمندريت توما بيطار*

اولاً :
الرّبّ يسوع يطلب أن يَثبت الّذين آمنوا به على كلامه.
والثّبات على كلام الرّبّ يسوع معناه أن يعمل المؤمن على أن يسلك في الطّاعة أبدًا للرّبّ يسوع.
والطّاعة عمل شاقّ، عمل مُتعب.
الطّاعة تستلزم، أوّلاً، أن يكون المؤمن مستعدًّا لأن يتخلّى عن رأيه،
وينبذ مشيئته، ويتمسّك بالكلام الإلهيّ في كلّ حال.
طبعًا، هذا ليس بالأمر السّهل؛ لأنّ الإنسان مائل، بسبب السّقوط، بصورة تلقائيّة،
إلى صنع مشيئته، وإلى الالتزام بأهوائه.
لذلك، أكثر المؤمنين يعانون من تغيير الفكر باستمرار:
مرّة، يسلكون بحماسة وأمانة، من جهة الكلام الإلهيّ؛
ومرّة أخرى، يستسلمون لنزوات أنفسهم.
طبعًا، إن استمرّت هذه الحال، فلا يمكن إلاّ أن تؤدّي بالمؤمن إلى الفتور؛
ومن ثمّ، إلى الشـّرود.
لهذا السّبب، على المؤمن أن يتمنطق بروح القوّة، أوّلاً وقبل كلّ شيء!
عليه أن يتعلّم كيف يغصب نفسه لإتمام الكلام الإلهيّ.
من دون غصب النّفس، مستحيل على الإنسان المؤمن بيسوع أن يَثبت في الأمانة له.
إن لم يثبت الإنسان في الكلام الإلهيّ، إن لم يغصب نفسه عليه؛
فإنّه سيجد نفسه، بصورة تلقائيّة، غارقًا في أوهامه، وخيالاته، ورغباته.
لذلك، هناك معركة تدور، في الحقيقة، في نفس كلّ مؤمن، بينه وبين نفسه،
بينه وبين إرادته، بينه وبين أهوائه…
هذه هي المعركة الكبرى الّتي يجب على كلّ إنسان أن يخوضها.
ليكنْ كلّ واحد منّا عالِمًا أنّ السّلوك في الإلهيّات لا يمكن أن يأتي عفوًا!
هناك فعل عنف لا بدّ من أن يمارسه كلّ إنسان في تعاطيه الكلام الإلهيّ،
أي في تعاطيه الله، إذ لا مسافة بين الله وكلامه:
“مَن يحبّني، يسمع كلامي” (يو14: 23).
إذًا، المطلوب هو غصب النّفس في كلّ حال، وفي كلّ أمر؛
وأن يكون المؤمن مستعدًّا لأن يتخلّى عن رأيه،
لكي يثبت في الكلام الإلهيّ، ولكي يكون لروح الرّبّ مكان في نفسه.
ثانيًا،
الميل عند كلّ إنسان، كما قلت، هو إلى السّلوك بحسب أهوائه وأفكاره.
لكن، هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو أن يدخل المؤمن في عمليّة تلفيق،
فيخلط ما بين الإلهيّات وما لنفسه.
يختار من الإلهيّات ما يناسبه، ويتخلّى عمّا لا يناسبه.
طبعًا، عند الإنسان القدرة على أن يبرّر نفسه، إذا شاء.
لكنّ الرّبّ الإله، علاّم القلوب، يعرف ما إذا كنّا نسلك في الحقّ أو في الباطل.
لهذا السّبب، علينا أن نتعب، لا سيّما في الصّلاة إلى الله،
لكي يعطينا الحكمة على معاينة مشيئته في كلّ حين، وفي كلّ حال.
الحياة الرّوحيّة كلّها قائمة في هذا الإطار.
وليس أسهل على الإنسان من أن يقتبل ما يناسبه من الإلهيّات، ويُسقط ما لا يناسبه.
وهذا صحيح، بصورة خاصّة، اليوم، فيما بيننا؛
لأنّ الإنسان بات معتَدًّا بقواه الإدراكيّة، بعقله، بإنجازاته…
وبات، أيضًا، مُشبَعًا بروح النّقد؛ ويتعرّض، بسهولة، للإلهيّات.
مخافة الله يبدو أنّها تضعف في النّفوس.
كلّما اعتمد الإنسان على عقله، اهتمّ باتّخاذ العلوم قاعدةً لتعاطي الإلهيّات.
لكنّ العلم كثيرًا ما ينفخ. المحبّة وحدها تبني.
لهذا السّبب، الإنسان الّذي يشاء أن يدخل في المسار الإلهيّ عليه أن يتعلّم،
أولاً وقبل كلّ شيء، كيف يصمت، وكيف يجعل عقله يصمت بإزاء الله:
“تكلّم، يا ربّ، فإنّ عبدك يسمع” (1صم3: 9)!
الإنسان، اليوم، لا يسمع كثيرًا.
وإذا ما سمع، فلكي يتكلّم، لكي يتّخذ ممّا يسمعه مناسبةً للدّخول في سجال، للدّخول في نقاش…
إنسان العقل، بكلّ أسف، ينمو على حساب إنسان القلب!
هَمُّ الإنسان، بالأكثر، أن يجعل فكره سديدًا، منطقيًّا!
الهَمُّ الأوّلُ للإنسانِ أن يتعلّم فنّ المحادثة والإقناع!
لكن، في مقابل ذلك، قلّما ينظر الإنسان، اليوم، إلى قلبه، إلى كيانه،
إلى فكره الدّاخليّ؛ وقلّما يسعى لتنقية قلبه. لذلك، قلّة منّا تعرف نفسها على حقيقتها.
الإنسان، اليوم، مأخوذ بالمظهر. هَمُّه الأوّل أن يظهر ثمينًا، تقيًّا، عارفًا…
وهذا كلّه يقتل، في نفسه، أو يُخرس، في قلبه، الاستعداد العميق لسماع الكلمة الإلهيّة.
الإنسان يدور في فلك نفسه.
من هذا المنطلق، وإن كان النّموّ في القوى الإدراكيّة، عند الإنسان،
وفي العلوم والمعارف، قد أمّن له، في الظّاهر، حياة من الرّخاء والبحبوحة؛
إلاّ أنّه، من دون شكّ، انعكس سلبًا على نظرة الإنسان إلى نفسه؛
ومن ثمّ، على نظرة الإنسان إلى ربّه! فمن حيث نظرة الإنسان إلى نفسه تلقاه، اليوم،
في أقلّ ما يُقال، مغرورًا بنفسه. والغرورُ، متى ازدوج بالفردانيّة،
يجعل الإنسانَ أكثر استعدادًا لعبادة فكره ومشيئته،
وأكثر استعدادًا للتّعاطي مع الله بطريقة استنسابيّة؛ فلا يشاء أن يسمع ما يقوله الله له،
بل يهمّه أن يختار ما يناسبه!
على هذا، نجد، اليوم، أنّ أكثر النّاس يمارسون العبادة كلٌّ على طريقته.
كلّ فرد يكوّن إلهه بالطّريقة الّتي تناسبه: يزيد شيئًا من هنا، يُنقص شيئًا من هناك…
لهذا السّبب، يصعب جدًّا أن نجد أنّ الإله الّذي تعبده جماعة ما هو واحد.
في الحقيقة، يبدو أنّهم يعبدون آلهة مختلفة. من جهة أخرى، الإنسان، اليوم،
بسبب غروره، بسبب انتفاخه، بسبب ما حقّقه ويحقّقه من إنجازات في المستوى الدّهريّ،
آخذٌ، لا فقط في مناقشة الله، بل في مجادلته، أيضًا!
لذلك، يتألّم الإنسان حين يرى أنّ ما يُعرف بالتّراث، في الكنيسة، هو موضع تشكيك عند الكثيرين.
ما يقبله فلان لا يقبله، بالضّرورة، آخر. طبعًا، هذا يخلق نوعًا من الدّيانة الفردانيّة؛
ويقتل روح الجماعة؛ ويجعل الله، بالأحرى، صورة عن تصوّرات النّاس. كلّ هذا، في الحقيقة،
يجعلنا نستغرق في نوع من العبادة الدّهريّة. الكنيسة تغزوها الدّهريّة من كلّ جهة.
ويَعسُر كثيرًا، اليوم، أن يجتمع، ولو القلّة، على فكر كنسيّ واحد!
لكلّ واحد رأيه، لكلّ واحد فكره!
كلّ شيء بات نسبيًّا!
بإزاء هذه الحال، يعود الكلام الإلهيّ ويأتينا، داعيًّا إيّانا إلى أن نثبت في الكلام الإلهيّ.
موقفنا إزاء الرّبّ الإله ينبغي أن يكون، في الدّرجة الأولى، موقف إنسان يعرف أنّه لا يعرف!
ينبغي أن يكون موقف ولد من جهة أبيه:
يريد أن يتعلّم، يحتاج إلى أن يكشف له الرّبّ الإله، بروحه القدّوس، الحقيقة لكي يسلك فيها.
نحن ليس بإمكاننا، ولا بطريقة من الطّرق، أن نفهم الكلام الإلهيّ إلاّ بروح الله؛
لأنّ ما أتى بروح الله لا يمكن أن يُستوعَب إلاّ بروح الله!
ولكي نُعطى الرّوح، نحتاج إلى تواضعٍ كبير، تواضعٍ في كلّ مستوى،
لا سيّما في مستوى الفكر، وفي مستوى القلب. الله لا يتكلّم، أبدًا،
إذا كان الإنسان مُمتلـِئًا كلامًا من عنده!
“إن لم ترجعوا وتصيروا كالأولاد، فلن تدخلوا ملكوت السّموات”
(متّى18: 3).
إذًا، علينا أن نقف من الله موقفًا كهذا؛ ونقف في الصّلاة طالبين إليه أن يعطينا روح الفهم.
ومتى كان الدّافعُ العميقُ هو معرفةَ الحقّ كما في قلب الله، فلا بدّ للرّبّ الإله من أن يكلّمنا
بطريقة أو بأخرى.علينا أن نتعلّم كيف نُفرغ، أوّلاً، أنفسنا؛
حتّى يتسنّى للرّبّ الإله أن يملأنا من حكمته، من معرفته، من حقّه.
هذا، في ذاته، جهد ليس بالقليل. ونحن، متى تلقّفنا الكشف الإلهيّ، وسلكنا فيه؛ فإنّنا،
إذ ذاك، إذا ما ثبتنا، نكون قد ثبتنا على كلام الله.
إذ ذاك، نعرف الحقّ والحقّ يحرّرنا. إذًا، الكلّ يرتبط بتواضع كبير ينبغي أن نتعاطاه،
وإلاّ لا نثبت في الحقّ، ولا نعرف الحقّ أبدًا، ولا نتحرّر!
نبقى في حدود خطايانا، في حدود سقوطنا، في حدود أفكارنا،
مهما بدت لنا أفكارنا برّاقة، وجميلة، وبليغة. لاحظوا، هنا،
أنّ الحرّيّة مرتبطة بالثّبات في كلام الله؛ ومن ثمّ، بمعرفة الحقّ.
الحقّ يعني الحرّيّة، الّتي تأتي من الثّبات في الحقّ.
وإذا ما تابعنا الكلام الإلهيّ، فإنّنا نجد، على العكس، أنّ الإنسان، كلَّ إنسان، في مقابل الحرّيّة،
عرضةٌ للعبوديّة. وإذا كانت الحرّيّة مرتبطة بالحقّ، فالعبوديّة مرتبطة بالخطيئة،
أي بعبادة الإنسان لنفسه، بتمسّكه برأيه، بسلوكه في أهوائه.
في هذه الحال يدور الإنسان في فلك نفسه، ويكون عبدًا، وربّما ظنّ نفسه حرًّا!
البشر، اليوم، يظنّون أنّ لهم الحقّ أن يقولوا كلمتهم؛ وأنّهم، متى قالوا كلمتهم، صاروا أحرارًا!
هذا غير صحيح. الإنسان يصير حرًّا، إذا عرف الحقّ الإلهيّ، وتمسّك به، وتخلّى عن رأيه الذّاتيّ.
إذًا، العبوديّة، فيما بيننا، نسمّيها، اليوم، حرّيّة:
حرّيّة الفكر، حرّيّة الاختيار، حرّيّة الصّحافة… الحرّيّات عامّة!
لكنّ هذه الحرّيّات، ما دامت مرتبطةً بعبادة الإنسان لنفسه، أي بخطيئته،
فهي عبوديّات، وليست بحرّيّات، أبدًا. العبد لا يثبت في البيت إلى الأبد؛
أمّا الابن، فيثبت في البيت إلى الأبد. فإن حرّركم الابن، صرتم أحرارًا حقًّا.
الإنسان لا يستطيع أن يحرّر نفسه، ولا بشكل من الأشكال.
هو ساقط في حبّه لذاته، في عشقه لنفسه، في عشقه لكلّ ما له علاقة بنفسه.
لذلك، لا يمكنه، مهما فعل، أن يخرج من هذه الحفرة الّتي وقع فيها منذ سقوط آدم.
الابن هو الّذي يحرّركم، هو الّذي يحرّرنا!
والابن، ابن الله، يحرّرنا بالحقّ؛
ونحن نقتبل الحقّ بتواضع قلب، بالصّمت، بالإيمان، بالطّاعة، بالثّبات، بغصب النّفس…
بكلّ هذه الأمور وغيرها يتحرّر الإنسان.
إذًا، ليس كلّ مَن يظنّ نفسه مؤمنًا هو مؤمن بالفعل.
فقط الّذي يسلك في ما لله، فقط الّذي يسلك في الحقّ الإلهيّ،
فقط الّذي يسلك في تواضع القلب، هذا هو الّذي يكون مؤمنًا بالرّوح والحقّ.
فمتى سلك الإنسان على هذا النّحو، صار ابنًا لله.
عند الله، ليس هناك عبيد، على الرّغم من أنّنا، في عبادتنا،
كلّ واحد منّا يقول عن نفسه إنّه عبد الله، أو أمة الله.
لكنّ الله، في نظرته إلينا، يتعاطى معنا كأبناء، لا كعبيد.
نحن أهل بيت الله! العبد هو الّذي يصنع الخطيئة.
وإذا كان صانعًا للخطيئة، فهو ليس، فقط، عبدًا لها؛ بل هو، أيضًا، ابن للشـّيطان.
يشير الرّبّ يسوع في كتابه إلى أنّ الإنسان هو الّذي يصنع الخطيئة،
أي الّذي يحبّ نفسه ويعبدها، ويعشق أهواءه،
هذا الإنسان، من حيث يدري ولا يدري، هو ابن للشـّيطان!
لم يقل الرّبّ يسوع عبثًا عن اليهود ولليهود:
“أنتم من أب هو إبليس، وأعمال أبيكم تعملون” (يو8: 44).
الموضوع ليس ما يظنّه الإنسان، بل ما يفعله الإنسان بإزاء الله،
وبإزاء الكلام الإلهيّ والحقّ الإلهيّ.
إذًا، مَن يعمل أعمال الله، فهذا يصير ابنًا لله؛
ومَن يعمل أعمال الشـّيطان، فهذا يصير ابنًا للشـّيطان.
ليس هناك حياد بين ما هو لله وما هو للشـّيطان:
“مَن ليس معي، فهو عليّ”! [مَن ليس معي، فهو مع إبليس] (لو11: 23)!
لذلك، إبليس هو الّذي صلب الرّبّ يسوع، من خلال البشر الّذين جعلوا أنفسهم أدوات له،
وعملوا ما أوحى لهم به. لذلك، هنالك طريقان:
طريق الحقّ، وطريق الخطيئة.
الحقّ يستلزم الطّاعة، والطّاعة تستلزم الاتّضاع، والاتّضاع يستلزم إفراغ النّفس،
وإفراغ النّفس يستلزم أن يعتبر الإنسان نفسه جاهلاً وترابًا ورمادًا.
هذه هي طريق الحقّ والحياة.
والطّريق الأخرى هي طريق الخطيئة.
مَن يصنع الخطيئة، فإنّه يستلذّها؛ ومتى استلذّها، فإنّه يعتاد عليها؛
ومتى اعتاد عليها، فإنّه يصبح أسيرًا لها؛
ومتى صار أسيرًا لها، فقد حرّيّته بالكامل،
وصار عبدًا لا للخطيئة فحسب،
بل لمَن هو وراء الخطيئة، أي لإبليس.
لذلك، نحن لا يمكننا، يا إخوة، إلاّ أن نتمنطق بروح القوّة،
ونسلك في ما لله؛ فإن لم نفعل، فإنّنا، من حيث ندري ولا ندري،
سننزلق إلى جبّ الهلاك، وسوف نجد أنفسنا، رغمًا عنّا،
نتمّم أعمال إبليس كما فعل اليهود!
اليهود كان عندهم كلّ شيء:
كان عندهم الأنبياء، والنّاموس، والحكمة، والهيكل،
وجاء الرّبّ يسوع وأقام في وسطهم.
وعلى الرّغم من ذلك كلّه، كانوا أولادًا للشـّيطان.
لا يظنّنّ أحد منّا أنّنا، اليوم، في كنيسة المسيح، مستمرّون بصورة تلقائيّة!
إن لم نسلك في التّعب، في غصب النّفس، إن لم نسلك في العنف بإزاء مشيئاتنا وأهوائنا؛
فإنّنا نكون، ظاهريًّا، لله؛ غير أنّنا نكون، في العمق، عملاء لإبليس!
ولا ينسينّ أحد منّا أنّ “ضدّ المسيح” يأتي، كما تكلّم يوحنّا الحبيب،
وهو قد أتى منذ الزّمان الأوّل، وهناك أضداد كثيرون للمسيح.
وفي نهاية المطاف، يمكن الإنسان أن يعبد “ضدّ المسيح”،
الّذي يكون في الظّاهر كأنّه المسيح، لكنّه في الرّوح يكون مقاومًا له.
الخطورة، دائمًا، هي أن يوجَد العديد من المؤمنين خدّامًا لضدّ المسيح،
في كنيسة المسيح، وهم لا يعلمون. هؤلاء يُفسدون أنفسهم، ويعملون على إفساد شعب الله.
لكن، لا شكّ في أنّ ساعةً آتية سوف يتمّ فيها الفرز، وسوف يجتمع مَن هم لله إليه،
ومَن هم لضدّ المسيح إليه.
أمّا نحن، فعلينا أن نعود إلى ذواتنا، لنبدأ كأنّنا أطفال،
ونتعاطى الكلام الإلهيّ بمخافة الله،
وباحترام كبير لتراث الآباء القدّيسين.
إن فعلنا ذلك، نصون أنفسنا من تجارب كثيرة تحتفّ بنا، اليوم.
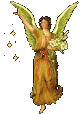 فمَن له أذنان للسّمع، فليسمع.
فمَن له أذنان للسّمع، فليسمع.